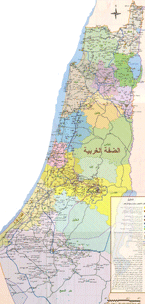14 أبريل, 2019 دروس من التجربة السودانية (1)
دروس من التجربة الإسلامية في السودان (1)
مقدمة
تعد التجربة السودانية للحركة الإسلامية واحدة من أهم التجارب الحديثة التي مرت بها الحركة . ومن المفيد أن نلقي بعض الاضواء على تلك التجربة التي امتدت عبر أكثر من ستة عقود اي منذ إنشاء الفرع السوداني لجماعة الإخوان المسلمين في اربعينيات القرن الماضي.
ولعل من المفيد ان ندرك ايضا طبيعة الجغرافيا والديمغرافيا واثرهما في تكوين الرؤية السياسية والاجتماعية لحركات التغيير. فضلا عن الوضع الإقليمي والدولي. فالجغرافيا السياسية تعطينا فكرة عن أهمية الموقع الجغرافي في طبيعة الأحداث التي تمر بها بلد من البلاد أو دولة من الدول. فالسودان يسمى "بوابة أفريقيا" العربية. ففي هذا البلد العربي الكبير مساحة (قبل فصل الجنوب) لديه الكثير من الموارد البشرية و المادية التي تؤهله للقيام بدور مهم في بناء علاقات إيجابية مع افريقيا. وقرب السودان من الجزيرة العربية ومصر ودول مهمة كاثيوبيا وأوغندا في شرقها وجنوبها جعل لها أهمية كبيرة. ولا أشك بأن دولة الاغتصاب الصهيوينة كانت دوما تنظر إلى السودان كمفتاح للدخول المباشر إلى افريقيا الشرقية تحديدا لبناء علاقات وطيدة معها.
أما الديمغرافيا فإن وجود عنصرين رئيسيين يشكلان الشعب السوداني الشقيق كان أمرا مهما في حركة التغيير. فالجنوب السوداني الذي كان لمجلس الكنائس العالمي دور مهم في بث "التنصير" وادعاء حماية المسيحيين هناك وتقديم الدعم المادي و المعنوي لها، وتحشيد القوى الغربية ضد الشمال بادعاء التمييز العنصري واحتكار السلطة والثروة في الشمال دور اساس في محاولات تمزيق السودان منذ حركة أنانيا 1 التي قامت مدعومة من الكنيسة بالتمرد تلو التمرد حتى تحقق للجنوب ما اراد بفصله عن الشمال عام 2011. ولعل الصورة الأخيرة للبابا وهو يقبّل اقدام زعامات الجنوب السوداني تعطي مؤشرا واضحا على التدخل الكنسي في تلك الدولة.
ومن المهم ايضا أن ندرك ان الحركة الإسلامية هناك –وهي تعيش جنوب مصر عبدالناصر ومبارك والسيسي لاحقا- وهم أعداء تقليديون للحركة الإسلامية، أن تتحرك بسهولة ويسر رغم ما طرأ من تغييرات على العلاقة بين البشر والسيسي لاحقا. فالحركة الإسلامية السودانية أخذت منهجا يقوم على الدعوة إلى عدم الارتباط بالإخوان في مصر من خلال التنظيم الدولي ، بل دعا الترابي – يرحمه الله- منذ وقت مبكر اي في ستينيات القرن الماضي إلى استقلالية الحركة الإسلامية. وهذا ادى إلى انشقاقات في الحركة الإسلامية عندما انشا جبهة الميثاق في أواسط ستينيات القرن الماضي وتحالف لاحقا مع النميري الذي أعلن عام 1977 "تطبيق الشريعة". وهي حركة خادعة من النميري مالبث أن بلعها الإسلاميون بدليل انقلابه عليهم وإيداع الترابي السجن لاحقا.
ولعل رؤية الترابي للعمل السياسي القائم على بناء تحالفات مع القوى السودانية المختلفة ومحاولته الدؤوبة للتغير في نبية النظام السوداني، قد عجلا بانقلاب البشير عام 1989. وهو انقلاب بلا شك تبنته الجبهة الإسلامية القومية بزعامة الترابي. وهذا الانقلاب لم يرق لمصر مبارك ولا دول الخليج وعلى راسها السعودية التي رأت في ذلك تحديا مباشرا لها. كما أن الغرب المناصر لفصل الجنوب عن الشمال والرافض لقيام دولة تحكم بالشريعة كان لهما اثر كبير على الأحداث التي تلت.
أما "حركة الإخوان المسلمين" فقد وقفت موقفا "مائعا" من الإنقلاب فلم تقف ضده أو تتعاون معه بشكل مباشر إلا من خلال المنشقين عنها كما يذكر د. عبدالوهاب الأفندي. وقد كان لهذا الموقف الآثار السلبية على الجماعة هناك. إذ تم ومن خلال الإعلام العربي و الغربي تصوير الانقلاب على أنه انقلاب إخواني. كما أن دعوة بعض الشباب الإخواني إلى مبايعة الترابي كما نشر ذلك عزام التميمي في مقال مشهور له في جريدة اردنية في منتصف التسعينيات، جعل من السهل تصويب السهام إلى حركة الإخوان المسلمين باعتبارها "متناغمة" مع انقلاب البشير –الترابي. إضافة إلى الدعاية الكبيرة والإيجابية التي حصل عليها الثنائي – البشير – الترابي في أوساط الإخوان المسلمين، ورأى بعضهم في تلك الحركة التغييرية أملا في نهضة المشروع الإسلامي.
وبعد الفراق الحاسم بين مجموعتي الترابي والبشير وخروج قادة من وزن د. غازي صلاح الدين العتباني من الحركة وتشكيل حركة جديدة معارضة لنهج البشير، لم يغير رؤية الإعلام والساسة للبشير على أنه "إخواني" ويمثل المشروع الإخواني ولذلك سارع الإعلام السعودي – الإماراتي تحديدا في الهجوم على "الإخوان المسلمين" باعتبارهم ممثلين للإسلام السياسي الفاشل. وهذا الهجوم من قبل إعلام الدولتين ينسجم مع عدائهما الصارخ والواضح للحركات الإسلامية في تونس و المغرب وليبيا ومصر ووقوفهما مع حفتروالسيسي وحتى القوى اليسارية المناوئة للإسلام في تونس وغيرها، لأنهما ينظران إلى الحركات الإسلامية نظرة ارتياب وخوف شديد.
وقد جاء انقلاب الرفاق على البشير خلال الأيام القليلة الماضية بسبب التحشيد الشعبي والرفض الكبير لنهج البشير الذي لم يعد يملك رؤية حقيقة للحكم خصوصا بعد زيارته لسوريا وقبل ذلك الدفع بالجيش السوداني لمحاربة الحوثيين في اليمن والوقوف إلى جانب السعودية و الإمارات في تلك الحرب الفاشلة، فضلا عن السياسات الداخلية المتمثلة بتشبثه بالحكم وصعود نغمة التطبيع مع الصهاينة القشة التي قصمت ظهر البشير.